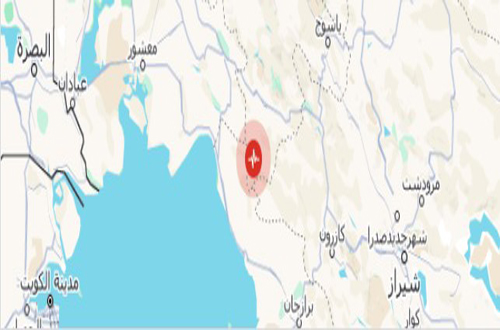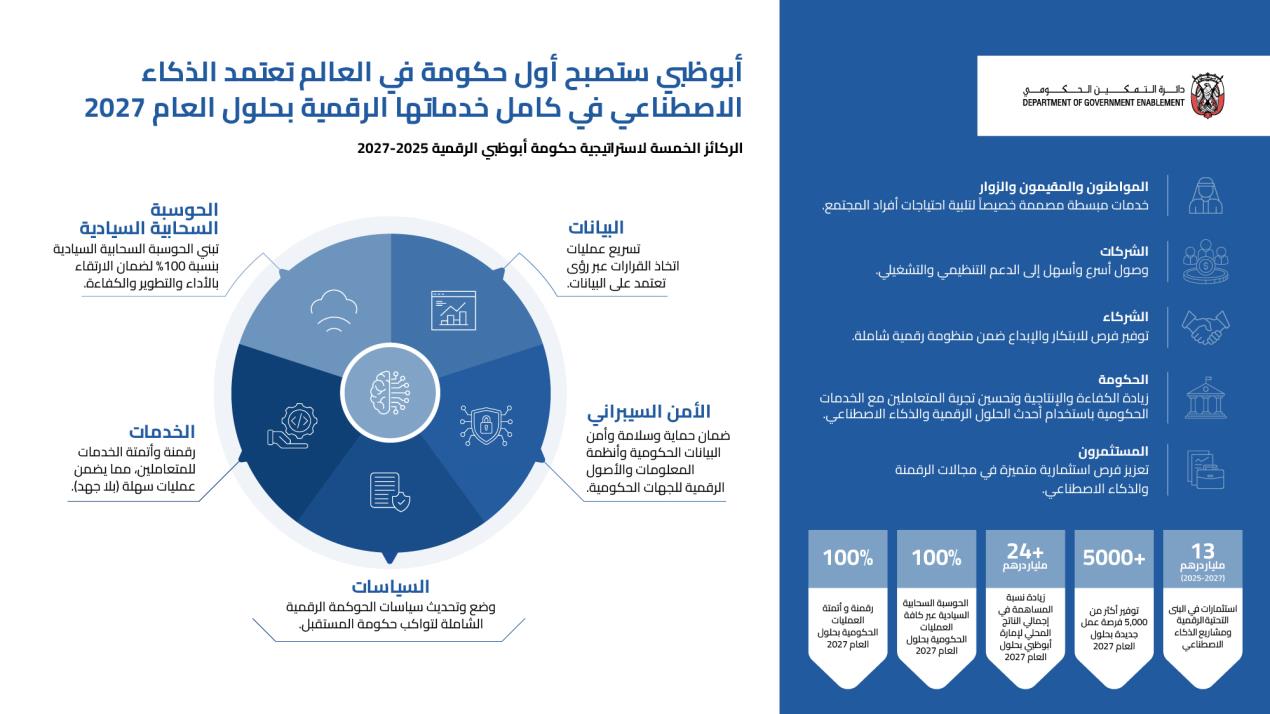أرض واحدة وثقافات متعددة ـ
- القسم : False
- تاريخ النشر : Sunday, November 12, 2017
- الجريدة : ميدل ايست اونلاين
- عدد المشاهدات : 1
- المصدر : إضغط هنا

ملامح رئيسة يمكن توصيف مصر الراهنة من خلالها.
هكذا تبدو لي تلك الملامح ومصر أيضا، منها على سبيل المثال الحاجة المعرفية الطارئة للتعدد الثقافي وقبول الآخر بقوة عن ما قبل من مؤتمرات وفعاليات ومشاركات تبدو صورية أو ورقية كانت تدشن من أجل الظهور الإعلامي ليس أكثر.
لكن اليوم أو بالأحرى الظروف الآنية تعددت الحركات الثقافية في مصر، وصار كل فصيل ثقافي سواء يحمل توجها دينيا أو فكريا أو سياسيا أو اجتماعيا يقبل فكرة حراك الآخر وحقه في الدفاع عن طروحاته التنظيرية التي قد تجد صدى وواقعا ملموسا بعد ذلك.
وكان قديما في عقود مبارك البائدة كان الحديث عن التعدد الثقافي والحاجة المعرفية إلى روافد ثقافية متباينة وغير متمايزة نسبيا ضربا من الرفاهية والترف، وكان أبرز نتائج هذه الرفاهية التجاهل القصدي لثقافات مصرية بيئية مثل النوبة وبورسعيد وسيناء بقبائلها العربية البدوية، وبقاع شتى بصعيد مصر، اللهم ثمة برامج ثقافية تذاع في الساعات الأولى من الصباح عن فنون تلك البقاع الساحرة وثقافاتها في برامج مكرورة أكثر مللا.
لكن اليوم التعدد والحاجة المعرفية باتت ضرورة ملحة ليس فقط من أجل تفاهم وتعايش إيجابي بل لأن هذا التعدد يقابله رواج اقتصادي وحراك اجتماعي يلقي بظلاله على المجتمع ككل.
واليوم في ظل هذا القبول لثقافات متباينة وجدنا اهتماما أكثر باللغة العربية والدفاع عنها وعن وجودها، وفي الدفاع عنها دفاع أول عن الثقافة العربية وخصوصيتها الفريدة، كما يرى كثيرون أن حالة التعدد الثقافي التي أنتجت نوعا من الدفاع عن اللغة من خلال سياقات ثقافية وطروحات فكرية مستعملة أقصى طاقات اللغة وبروتوكولات تشكيلها نوعا آخر من تجديد الليبرالية التي تعني حرية التعبير والتصوير.
ولا شك أن هناك ثمة علاقات موجبة بين الاستقرار الديموقراطي والتعدد الثقافي الحقيقي، فالمجتمعات المستقرة سياسيا والمكتملة لاستحقاقاتها الديموقراطية تجد في التنوع الثقافي فرصة طيبة لإثبات جدارة تطبيق الديموقراطية بنجاح وبغير استلاب سياسي أو إقصاء وتمييز لفصائل وأقليات.
لكن بالرغم من هذه الإشادة المستمرة بالتنوع الثقافي وتعدد الروافد والمشارب الثقافية في مصر، يظل هناك هاجس لسؤال مسكوت عنه دائما مفاده هل هناك مساواة في الفرص الثقافية؟
هذا السؤال ربما لا يحتاج إلى إجابة مكتوبة مثلما يفعل النخبة دوما، ويكررون منطقا بات فاقد الصلاحية للاستهلاك، لكن المساواة تتحقق بالفعل حينما نرتقب من الدولة المثابرة حقا على النجاح والارتقاء بالمواطن المصري الذي يستحق كل خير إلى مؤسسات فاعلة ترعى وتحمي التعدد الثقافي كما في سويسرا والنرويج وفرنسا على سبيل المثال.
إن النخبة فقدت الصلة تماما مع المواطن الذي اصبح يمتلك حلولا سريعة لمشكلاته السياسية والاجتماعية، ولم تعد قناعات النخبة كفيلة بإقناعنا بضرورة التفاعل الفكري مع طروحات نظرية بليدة ووئيدة ايضا.
وربما جاءت فكرة منتدى شباب العالم مؤخرا كبداية حقيقية تضمن التنوع الثقافي وقبوله من ناحية، ومن ناحية أخرى، أرى أن هذا المنتدى سيلقي أضواء كثيرة على ثقافات ليست في الخارج فحسب، فالذي يهمنا ويعنينا هو الثقافات المصرية بفنونها وأدوارها التي تتكامل وتنصر تحت مظلة ثقافية واحدة هي الثقافة المصرية.
ومصر مثل بقية دول العالم، في الوقت الذي تسعى إليه وغيرها من الأمم إلى اللحاق بركب الكونية، ترنو بقوة إلى تحقيق الخصوصية الثقافية وهي معادلة بحق صعبة لكنها ليست بالمستحيلة، وكما يقول الفيلسوف الكندي ذائع الصيت شارل تايلور بأن مطلب الكونية يحمل وعدا بالاعتراف بالخصوصية، وهو ما يشير إلى رفض التعارض والتناقض بين مطلب الكونية ومسعى الخصوصية.
وبالأمس كنت أعيب كثيرا على بعض فئات الشعب المصري المنتمين إلى بيئات تحمل ثقافات نوعية مثل بورسعيد وسيناء والنوبة عزوفها شبه المطلق عن المشاركة في الحراك السياسي لكن جاءت ثورتان في عصرنا الراهن يناير 2011 ويونيو 2013 لتضرب قوانين بائدة عرض الحائط.
والقضية ليست في مشاركة البعض كأقلية أو فئة ثانية في المجتمع، لكن الملمح الأبرز هو أن الفئات المتنوعة ثقافيا اقتنعت بعدم صحة فرضيات مبارك وأنظمته بأنها مواطنون من الدرجة الثانية بدليل أنهم أسهموا في المشاركة في إسقاط نظامين سياسيين في فترة وجيزة، الملمح الآخر هو أن الحراك السياسي الذي أعقب الثورتين سمح لكل فصيل وتيار وأصحاب عقائد متباينة بأنه لا وقت للإقصاء أو التمييز أو التهميش والاستبعاد الاجتماعي لأن الهم مشترك والقضية واحدة هي مصر العظيمة.
ووسط هذا الشعور الإيجابي الذي يدلل على الصحة النفسية للوطن والمواطن على السواء، جاء أمر الاندماج الثقافي أيضا ضرورة حتمية يفرضها واقع راهن يبدو مستقرا سياسيا، ولا بد من الإفادة بنتائج هذا الاندماج بمعرفة الواجبات قبل الحقوق، والإيمان بأن وطنا عظيما كمصر بحاجة معرفية إلى تكاتف مع الاحتفاظ بخصوصية نوعية في الثقافة والأعراف.
وبالمناسبة أن سقوط النخبة التي امتلكت لسنوات بعيدة حق إحداث الحراك الثقافي الصوري عقب سقوط نظام مبارك وسياساته البائدة كان دافعا قويا وحقيقيا لعدم استقطابهم لثقافة دون أخرى، وعرفت المجتمع المصري على ثقافات كانت بميدان التحرير وقت الثورتين يناير ويونيو، وهذه الثقافات وأصحابها أسهموا في القضاء على حالات الجهل والتنافر صوب الآخر.
وإذا راجعنا كيف نجح الإرهاب في التغلغل في المجتمع المصري، وكيف نجح على التخصيص تنظيم الدولة الإسلامية في اقتناص الكثير من المكاسب في الأراضي العربية، لفطنا إلى أن تيارات الإرهاب والتطرف دوما تلعب على فكرة التمايز الثقافي لبيئات بعينها مع توهين بقية الثقافات الأخرى، وتكريس الدعوة إلى الإقصاء والتمييز الأمر الذي يجعل لفصيل أو طائفة اجتماعية معينة ميزات دون الأخريات من الطوائف الثقافية، وكثيرا أشرت إلى أن القضاء على الإرهاب ينبغي أن يعالج ويحل بطرق سياسية وثقافية وليست حلولا أمنية وعسكرية فقط.
أردت أن أخصص سطورا قليلة عن التعليم المصري، فرغم محاولات التطوير والتحديث إلا أن الواقع الثقافي للمدرسة الابتدائية على وجه التحديد يفرض تحديات صعبة المراس والتأويل وربما العلاج بطرائق سريعة.
فالتطوير لم يعد قاصرا على إعداد برامج معاصرة ونقل خبرات أجنبية لدول راقت للرقي والتطوير، ولم يعد قاصرا أيضا على إعداد المعلم وتمكينه من فرص الممارسة النشطة للتدريس، فهذا ما اعتدنا قوله وفعله وتطبيقه، لكن الأجدى هو دراسة واقع الطفل المصري وثقافته البعيدة عن مظان تطويرنا، هذا الطفل الذي يحمل مطامح بالتأكيد لا نعيها ولا نفطنها بل نحن رهائن حبس نظرية بياجيه عالم النفس بأن عقل الطفل صفحة بيضاء، هذه النظرية باتت في طي النسيان والتردي، على المهمومين والقائمين اليوم بتنفيذ دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير التعليم ومناهجه دراسة ما يريده المتعلم لا ما يرودونه هم بأفكارهم ونظرياتهم وأيديولوجياتهم التقليدية، الطفل هو المستهدف وهو الزبون الذي ينبغي إرضاؤه أولا مع التوفيق بين رغبات تعلمه ودوافع احتياجاته المعرفية والمهارية والمعرفة الواجب اكتسابها.
د.
بليغ حمدي إسماعيل